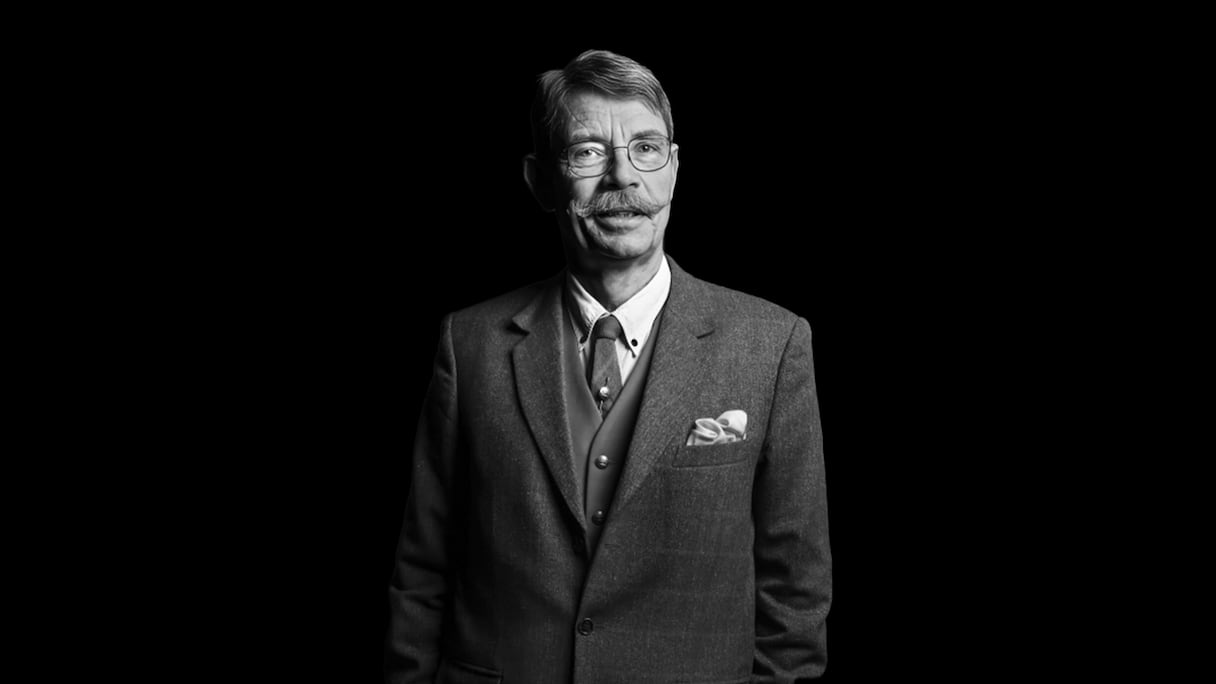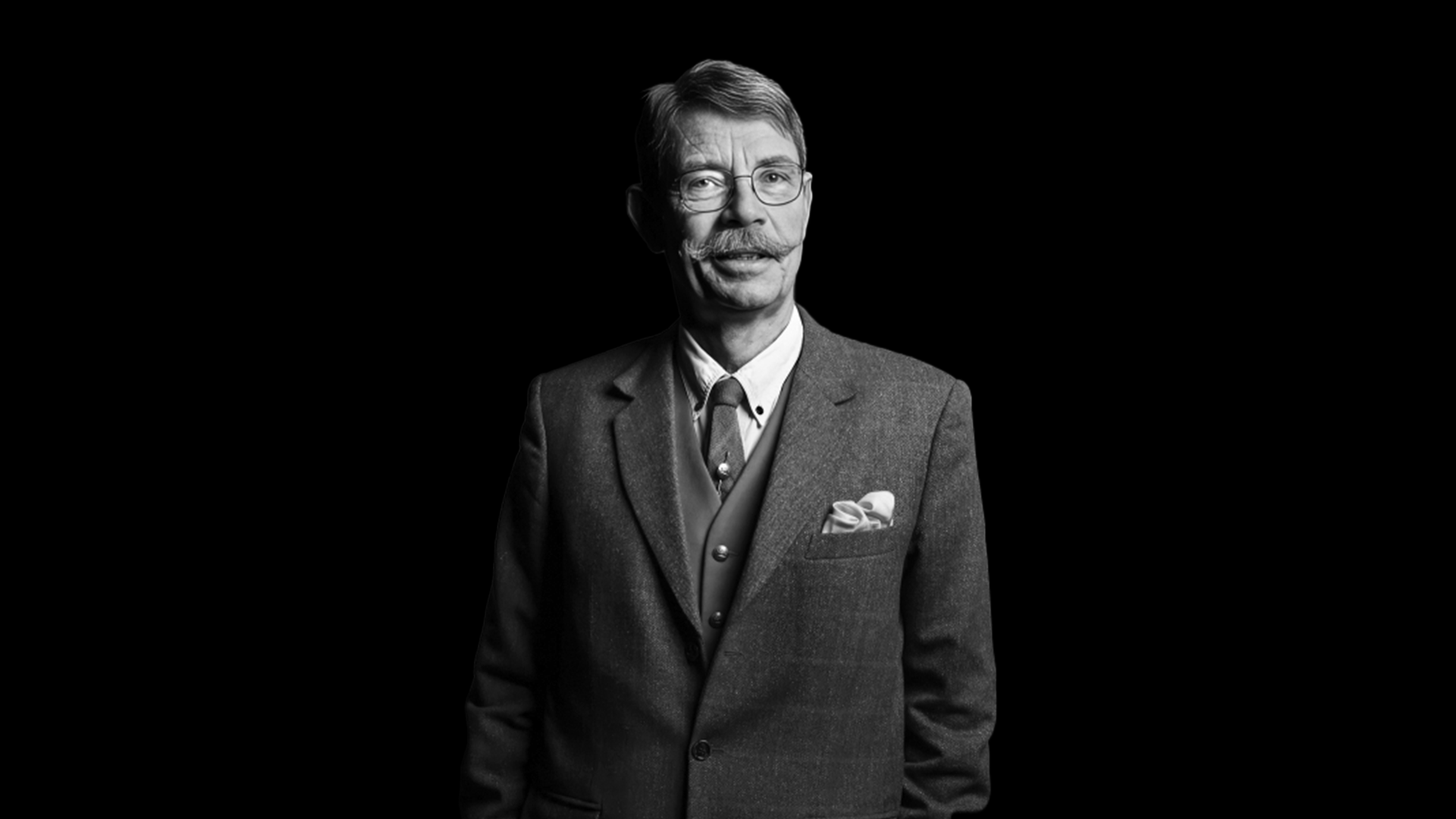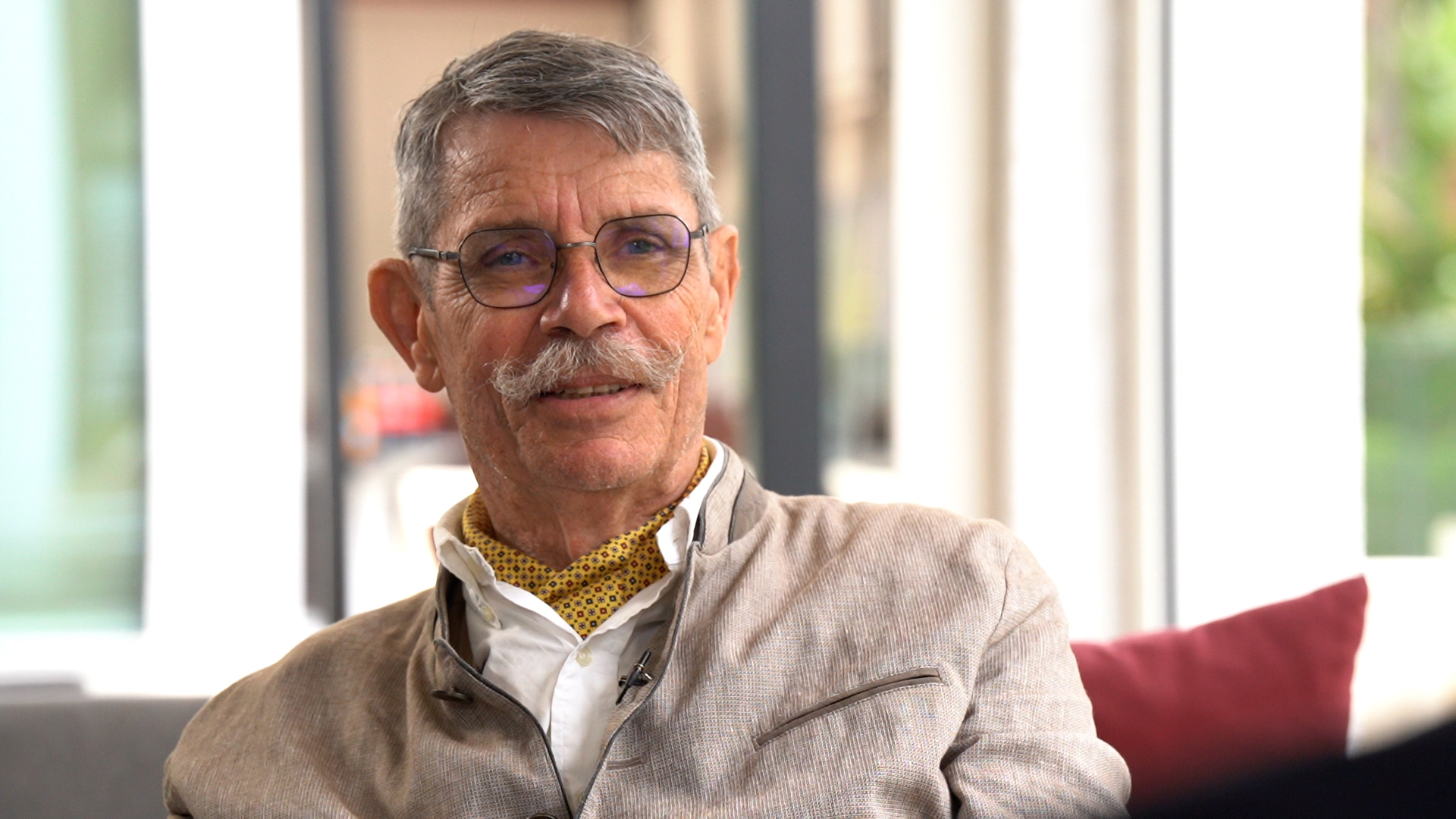وفي الوقت الذي تتجرأ فيه الجزائر، الدولة التي نشأت عام 1962، على الطعن في الحقوق التاريخية للمغرب على أقاليمه الصحراوية، فإنه من المفيد تذكير قادتها بأن المغرب كان يسيطر على طرق التجارة العابرة للصحراء في القرن العاشر الميلادي، أي قبل نحو ألف عام من ظهور الجزائر ككيان سياسي. وهذه حقيقة مثبتة تاريخيًا، إذ إن الجغرافي ابن حوقل وثّق هذه الطرق بنفسه.
كان الانطلاق من جنوب المغرب، وتحديدا من سجلماسة في تافيلالت، المدينة التي كانت على اتصال مباشر بمنطقة تاگانت على طريق وادي نهر السنغال. وفي القرنين الثاني عشر والثالث عشر، مع نشوء إمبراطورية مالي، ظهرت طريق تجارية جديدة، أيضا من سجلماسة، ولكن هذه المرة باتجاه الصحراء الوسطى نحو ممالح تغازة وواحة ولاتة. ومع أواخر القرن الرابع عشر، بدأت مدينة تمبكتو بالنمو، وسافر إليها الرحالة المغربي ابن بطوطة، حيث وصف الطرق التي كانت تؤدي إليها، والتي كانت تبدأ دائما من سجلماسة.
كانت سجلماسة بمثابة الميناء الشمالي للصحراء، ونقطة العبور الأساسية للقوافل المتجهة جنوبا أو العائدة منه. وكانت بمثابة حلقة الوصل بين المغرب وإفريقيا السوداء، حيث كانت تعج بالتجار القادمين من فاس ومدن مغربية ساحلية وداخلية، إضافة إلى تلمسان، التي ظلت مدينة مغربية لعدة قرون. وكانت سجلماسة تتمتع بموقع استراتيجي، إذ تبعد ستة أيام مشيا عن ورزازات، وتسعة إلى أحد عشر يوما عن فاس، وعشرين يوما عن طنجة، واثني عشر يوما عن تندوف.
إضافة إلى موقعها المتميز، استفادت سجلماسة من وفرة المياه التي سمحت بزراعة الخضروات والفواكه والحبوب الضرورية للقوافل، مما جعلها نقطة تموين أساسية للقوافل القادمة من الشمال والمتجهة إلى الصحراء، حيث تحتاج هذه القوافل إلى زاد يكفي لشهرين من السفر عبر 1500 إلى 1800 كيلومتر من الصحراء القاحلة.
في مقال هام نُشر عام 1969 بعنوان « سجلماسة: المدينة وعلاقاتها التجارية في القرن الحادي عشر وفقا للبكري " (Hesperis-Tamuda, vol X, fasc. 1-2, 1969)، قام الباحث جان ميشيل ليسارد بتعريف دور سجلماسة بوضوح: « كانت المدينة الفيلالية نقطة تجمع للقوافل القادمة من الساحل المتوسطي، ومن الساحل الإفريقي، ومن التل والسهول الشمالية للمغرب. كانت تستقبل البضائع، وتعيد توزيعها، وتزود القوافل بحمولتها العائدة التي يتم الحصول عليها من محيط المدينة أو من أعماق الصحراء. لقد كانت سجلماسة عنصرا محركا للتجارة الإقليمية والدولية على حد سواء. » (Lessard, 1969: 15)
كانت القوافل القادمة من الجنوب تحمل الذهب المستخرج من بامبوك، بالقرب من نهر السنغال، ومن بوراي على نهر النيجر، ومن منطقة اللوبي على نهر فولتا. ولم يكن الذهب وحده المنتج الرئيسي، إذ كانت تجارة الصحراء تشمل أيضا العنبر الرمادي، والصمغ العربي، وجلود المها التي كانت تُستخدم في صناعة الدروع، وجلود الفهود والثعالب الصحراوية، إضافة إلى تجارة الرقيق.
وبينما كان المغرب يصدر إلى إفريقيا السوداء منتجاته الحرفية مثل المجوهرات، والأسلحة، والأقمشة، والأواني المنزلية، والفخار، والسكاكين، والمرايا، والخيول، فإن تدفق هذه التجارة تعرض لهزة عنيفة في القرن الخامس عشر مع وصول البرتغاليين الذين استقروا على الساحل الغربي لإفريقيا.
أدى هذا التدخل البرتغالي إلى تحويل مسار التجارة من محور « إفريقيا السوداء - المغرب » إلى محور « إفريقيا السوداء القارية - إفريقيا السوداء الساحلية ». ونتيجة لذلك، تراجع الإنتاج الحرفي المغربي الذي كان يزود التجارة العابرة للصحراء، حيث بات الأفارقة يحصلون على المنتجات المصنعة في البرتغال عبر السفن البرتغالية، مما تسبب في أزمة اقتصادية في المناطق الجنوبية للمغرب، لا سيما في تافيلالت.
إقرأ أيضا : المؤرخ الفرنسي برنارد لوغان يكتب: هل تُدار الجزائر من المرادية أم من تندوف؟
ومما زاد الوضع تعقيدا توسع إمبراطورية السنغاي، أو إمبراطورية غاو، ما أدى إلى فتح طرق تجارية جديدة شرقا، وتحولت التجارة تدريجيا إلى مناطق الطوار، والقورارة، وهي مناطق مغربية أخرى كانت الطرق المؤدية إليها وإلى غاو أكثر مباشرة.
لكن مع قيام الدولة السعدية في المغرب، دخلت العلاقات مع إمبراطورية السنغاي في مرحلة من التوتر، لدرجة أن الحاكم السنغاي، أسكيا إسحاق الأول (1539-1545)، أرسل في أربعينيات القرن السادس عشر عدة مئات من الطوارق لمهاجمة المنشآت المغربية في وادي درعة. وتصاعد التوتر أكثر خلال فترة حكم السلطان المغربي أحمد المنصور الذهبي (1578-1603) وحكم أسكيا محمد الثالث الحاج (1582-1586).
في عام 1581، عزز المغاربة الحاميات العسكرية في منطقتي الطوار والقورارة، تمهيدا لحملة عسكرية ضد إمبراطورية السنغاي. وبالفعل، في عام 1590، جهّز السلطان المنصور جيشا قوامه 30,000 جندي، مدعوما بـ8,000 جمل و1,000 حصان، وأسند قيادة هذه الحملة إلى الباشا جودر، وهو قائد من أصول إسبانية.
انطلقت الحملة العسكرية من مراكش، وبعد 135 يوما وصلت إلى نهر النيجر، ثم تقدمت باتجاه غاو، حيث دارت المعركة الحاسمة في 13 مارس 1591، والتي انتهت بهزيمة قوات أسكيا إسحاق الثاني بعد خسائر فادحة. استولى المغاربة على غاو، وبدأت المفاوضات بين الباشا جودر وملك السنغاي، غير أن السلطان المغربي رفض تقديم أي تنازلات وأصر على فرض سيطرته الكاملة. وفي يونيو 1591، استبدل المنصور الباشا جودر بقائد آخر هو محمود بن زرقون، وكلفه باستكمال السيطرة على البلاد، زوده بسفن قابلة للتفكيك لفرض السيطرة على نهر النيجر، الشريان الحيوي لإمبراطورية السنغاي.
نجح محمود بن زرقون في القضاء على جيش السنغاي، معلنا نهاية الإمبراطورية، وبهذا، أسس المغرب ولاية « باشوية السودان »، التي كانت تدار من قبل حاكم مغربي يعينه السلطان، ليصبح المغرب بذلك القوة المسيطرة في غرب إفريقيا.