في 18 أكتوبر، قدم النائب فريديريك بوتي (الحركة الديمقراطية المعروفة اختصارا بموديم-وسط)، بصفته مقررا، تقريرا إلى لجنة الشؤون الخارجية حول الفعل الخارجي للدولة وبشكل أكثر تحديدا بالدبلوماسية الثقافية وتأثير فرنسا.
في هذا التقرير المكون من 70 صفحة، والذي لم يتم نشره بعد، ولكن تمكنت Le360 من الاطلاع عليه، اختار النائب تخصيص الجزء الثاني منه للعمل الثقافي والتعاون في الجزائر، حيث ذهب في مهمة إلى الجزائر العاصمة ووهران في شتنبر الماضي.
بعد لقائه بالعديد من الدبلوماسيين وأعضاء المجتمع المدني ورجال الأعمال، تحدث فريديريك بوتي بدون مواربة عن العلاقات الكارثية بين فرنسا والجزائر، مما شجع واضع هذا التقرير على الدفاع عن فوائد الدبلوماسية غير الحكومية للتغلب على الانسداد السياسي. وبعبارة أخرى، فهو يوصي بتجاوز السلطة القائمة للحفاظ على الروابط مع المجتمع الجزائري.
دبلوماسية السفارات مقابل دبلوماسية المجتمعات المدنية
وقال فريديريك بوتي في المقدمة التي تلخص بشكل جيد العلاقات الفرنسية الجزائرية: «هناك عدد قليل من البلدان، خارج الاتحاد الأوروبي، التي تقيم معها فرنسا علاقات وثيقة مثل الجزائر، في علاقة تبدو غنية على المستوى الإنساني ولكنها مختلة على المستوى السياسي». وتصطدم هذه العلاقات بالعراقيل الممنهجة للنظام القائم، على الرغم من المبادرات المؤيدة للجزائر التي تقوم بها رئاسة الجمهورية الفرنسية.
لأنه رغم الطموحات المعلنة لإحياء التعاون الفرنسي الجزائري، والتي نفذها في أقل من عشرين عاما ثلاثة رؤساء فرنسيين، من جاك شيراك إلى فرانسوا هولاند وإيمانويل ماكرون، فمن الواضح أن أيا من النوايا بكتابة صفحة جديدة في تلك العلاقات لم تنجح بسبب العراقيل الهيكلية للنظام الجزائري. إن مكانة فرنسا، كثاني مورد وثاني زبون وأحد المستثمرين الرئيسيين في الجزائر، لا يغير شيئا و«لم يشكل حتى الآن دافعا لتحسين العلاقات الفرنسية الجزائرية».
ولذلك، فإن الهدف من هذا التقرير هو إجراء فحص وثيق لمختلف آليات التعاون التي يمكن تفعيلها من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية، لأن «دبلوماسية السفارات» غير فعالة في حين أن «الدبلوماسية الحكومية»، التي تنهض بها المجتمعات المدنية، ضرورية لاستمراريتها وإمكاناتها، لا سيما في ما يتعلق بالثقافة والفرنكوفونية وتنقل الطلاب والتبادل الاقتصادي.
في مواجهة الخداع السياسي واستغلال الماضي من قبل «النظام»، تفرض الانتظارات العديدة للشباب الجزائري والتي تعتزم فرنسا الاستجابة لها، بأي ثمن، (تفرض) نفسها للحفاظ على مصالحها في الجزائر بشكل أفضل.
خارطة طريق إيمانويل ماكرون محكوم عليها بالفشل
إنشاء مجلس أعلى فرنسي-جزائري للتعاون على مستوى رئيسي الدولة وحوار الذاكرة من خلال إنشاء لجنة مشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين وتعزيز التعاون الثقافي والعلمي والاقتصادي... الكثير من الطموحات الجميلة التي كانت موضوع خارطة الطريق التي تم إعدادها بعد زيارة إيمانويل ماكرون للجزائر في عام 2022، ولكن على ما يبدو لن تؤتي ثمارها أبد.

وهكذا، يتوقع فريديريك بوتي أنه «على الرغم من أنه من الممكن جدا أن تجد بعض المشاريع المعلنة عنها ترجمة على أرض الواقع في السنوات المقبلة، فليس هناك شك في أن إعادة إطلاق التعاون بينهما ستواجه نفس العقبات التي واجهتها المحاولات السابقة، مثل إعلان الجزائر بتاريخ 2 مارس 2003، الذي كان من المفترض أن يهيئ لمعاهدة صداقة بين البلدين، والتي لم قط إعدادها».
الدليل على ذلك سلسلة من التوترات في العلاقات الثنائية، بين فبراير ومارس 2023، عندما قررت الجزائر «استدعاء سفيرها في فرنسا للتشاور بعد قرار فرنسا ممارسة الحماية القنصلية لصالح الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي أثناء تواجدها في تونس».
إن الاتصالات المتبادلة بين رئيسي الدولة من أجل «إزالة سوء التفاهم» لم تغير من الأمر شيئا، لأنه في رأي المقرر، «لا يمكن اختزال تقلبات التعاون الفرنسي-الجزائري في حاثة دبلوماسية». وهكذا، فإن العديد من المتدخلين الذين التقاهم المقرر في الجزائر واستشهد بهم يرون أن «الاتفاقيات الموقعة لا تلزم الشريك الجزائري». وبالتالي، «يبدو أن أي نهج مؤسسي بحت يصطدم لامحالة في الجزائر بعقبات متجددة باستمرار، والتي تجد أصلها في تنظيم الدولة الجزائرية نفسها»، يلخص مؤلف التقرير.
وهو ما يذكرنا أيضا بما لاحظه الخبيران الفرنسيان جون لوي ليفيت وبول توليلا خلال مهمتهما الحكومية التي استمرت خمس سنوات في الجزائر. وذكرا، في كتاب بعنوان «الداء الجزائري»، كيف يمكن للمحاور الجزائري للجانب الأجنبي أن يختفي بين عشية وضحاها دون تفسيرات ودون أن يترك أثرا. وقالا المؤلفان: «إن خسارة المحاور الجزائري هي نوع التقنية القديمة لقول «لا» والتخلص من المشاريع التي لم نعد نريدها، دون تحمل عناء توضيح السبب».
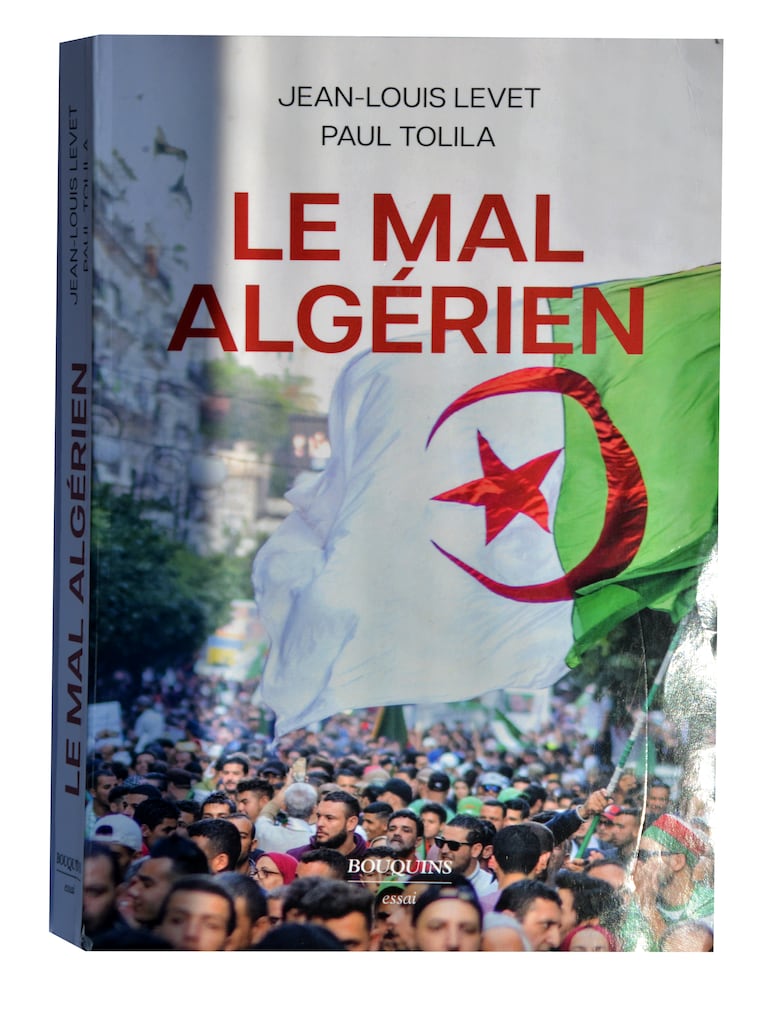
وأوضح المؤلفان أيضا أنه مع استخدام المحاورين الجزائريين لعناوين بريد إلكتروني خاصة، يصبح من الصعب للغاية الوصول إلى المؤسسات. ومن هنا يأتي هذا التعليق الواضح: «إن هذ الموقف هو بالتأكيد أحد أخطر المواقف وأخطرها على تطور الجزائر وسمعتها في إطار الشراكة الاقتصادية: فهو يؤكد على اللامبالاة الشديدة تجاه العقود الموقعة ويزيد من مخاوف الشركات الأجنبية تجاه بلد يسود فيه انعدام الأمن القانوني».
النظام الجزائري أصل الداء
لفهم أسباب عدم نجاح الطموحات الرئاسية الفرنسية في الجزائر بشكل أفضل، يستشهد فريديريك بوتي بكتاب جون لويس ليفيت وبول توليلا.
في هذا الكتاب المنشور عام 2023، يصف هذين الخبيرين العارفين بخبايا الجزائر طريقة عمل النظام الجزائري، «الذي يسيطر على جميع أدوات السلطة، والذي يعتبر أي شكل من أشكال التعاون مع فرنسا يمكن أن يكون ذا أهمية للمجتمع الجزائري بمثابة أمر ثانوي مقارنة بالمخاوف المرتبطة بالحفاظ على أمنه ومراقبة السكان وتدبير الريع الطاقي»، بحسب فريديريك بوتي.
ويتقاسم المقرر ومؤلفا كتاب «الداء الجزائري» نفس التقييم، فمن ناحية «الاهتمام بفرنسا من جانب قطاعات بأكملها من المجتمع الجزائري والفرص الكبيرة التي يمكن أن تنجم عنه، ومن ناحية أخرى، دولة تخنيق المجتمع الجزائري بأكمله، وبالتالي التعاون مع فرنسا».

فعلى سبيل المثال، وعلى الرغم من أقدميتها، فإن الغرفة الجزائرية-الفرنسية للتجارة والصناعة «غير مخولة بالدخول مباشرة في اتصال مع الإدارات الجزائرية ويجب عليها الاتصال بشكل ممنهج بالمكتب الاقتصادي الجهوي للسفارة الفرنسية، الذي يرسل مذكرات شفوية إلى الطرف الجزائري...»، يؤكد فريديريك بوتي.
ويؤكد النائب الفرنسي أيضا هذه الملاحظة التي لا تحتاج إلى تعليق: «إن عدم الاستقرار في الجزائر وعدم اتضاح الرؤية وهشاشة الإدارة، بما في ذلك في أعلى هرمها، (...) يجعل من الصعب للغاية تحديد محاورين دائمين لتنفيذ مشاريع طويلة المدى معهم».
وبالتالي فإن أي تغيير من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الشبكات والمصالح القوية القائمة. وهكذا «يتردد الوزراء مثل إداراتهم في اتخاذ مبادرات خوفا من تصفية الحسابات من خلال المتابعات القضائية». في هذا البلد حيث الجمود والصمت هو القاعدة، فإن «المشاريع تصبح دائما موضع تساؤل بسبب التغيير الدائم للوزراء وكبار المسؤولين والولاة».
العداء لفرنسا أصل تجاري في الجزائر
وبغض النظر عن عمل النظام السياسي الفاسد الذي يحافظ عن عمد على غموضه، والذي لا تزال فرنسا تكافح من أجل فك شفرته، فإن فريديريك بوتي يهتم في هذا التقرير بالعداء لفرنسا الذي يتغذى داخل المجتمع والذي يرهن في الواقع أي آفاق للتعاون بين الدولتين.
في الواقع، الجزائر ليست مهتمة بتعزيز علاقات ودية وهادئة بين باريس والجزائر، وفق تحليل النائب الفرنسي. والسبب هو أن العداء لفرنسا هو أصل تجاري في الجزائر. وأضاف أن هذا ريع الذاكرة مربح لـ«ما لا يقل عن 12 مليون جزائري مرتبطين بالعائلة الثورية، أي أحفاد المقاتلين الحقيقيين أو المفترضين في حرب الاستقلال»، يؤكد النائب الفرنسي. إن الجميع «يستفيدون، على هذا النحو، من المزايا المهمة التي تمنحها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق»، وبالتالي فـ«موقعهم المميز في المجتمع يعتمد بالتالي على إدامة الخطاب المعادي لفرنسا».
إذا كان المقرر يرحب بـ«الاهتمام الصادق الذي أبداه رئيس الدولة لقضايا التاريخ الفرنسي-الجزائري، من خلال سلسلة من الإجراءات، والتي كان لها تأثير واسع في فرنسا، وبعيدا عن أي استغلال سياسي للماضي»، فإنه يواجه بموقف مختلف تماما من الجانب الجزائري. «فيما يتعلق بموضوع أساسي لإضفاء الشرعية على السلطة الجزائرية مثل الاستعمار وحرب الاستقلال، يبدو أن التعاون الثنائي المؤسسي محكوم عليه بالسير في طريق مسدود، حتى أكثر حتما من الأشكال الأخرى من العلاقات الثنائية المؤسسية»، يضيف فريديريك بوتي. وفي الواقع، «في الجزائر، الإحالة إلى الحرب ليس لها فقط بعد خطابي، بل إنها الأساس السياسي والديني للنظام».
لذلك، ليس من المستغرب، بحسب فريديريك بوتي، أنه ضمن اللجنة المشتركة للمؤرخين التي شكلتها الدولتان، «قامت الجزائر بتعيين أكاديميين أكثر تطرفا. أصغرهم سنا، والذي رغم ذلك ناقش أطروحته في جامعة إيكس-مرسيليا، يدلي بتصريحات كاريكاتورية».
تقوية المشاعر المعادية لفرنسا، سياسة عمومية
بالنسبة لفريديريك بوتي، فإن خطاب العداء المستمر تجاه فرنسا يجد جذوره أيضا في «التقدم المستمر للإسلاموية داخل المجتمع»، الملحوظ بشكل خاص في «الانتصار الاجتماعي للقيم الدينية والمحافظة»، وكذلك على مستوى «تعزيز وجود رجال الدين في المجال العام، ولكن أيضا في التعليم والجامعات». وهكذا، أصبح أي تقارب بين القادة السياسيين الفرنسيين-الجزائريين شبه مستحيل، كما يقول المقرر.
ولكن بنفس الطريقة التي تستفيد بها الإسلاموية والخطاب المناهض لفرنسا من «الدعم الضمني للسلطات»، فمن الواضح أن «السياسات العمومية، التي يديرها على مدى جيلين، تهدف إلى الحد من استخدام اللغة الفرنسية»، مع النتيجة المباشرة لإضعاف النخب الناطقة بالفرنسية وتعزيز المشاعر المعادية لفرنسا.
وكمثال على ذلك، يقارن فريديريك بوتي بين «المدرسة الثانوية الفرنسية» الوحيدة في الجزائر وبين المؤسسات السبعة عشر الموجودة في المغرب. هذه المؤسسة الفريدة، اليوم «الممتلئة تماما»، تتهاطل عليها طلبات التسجيل، ولكن من دون أن تكون قادرة على قبولها. والسبب، يوضح المؤلف، أن «هذه الطلبات الكثيرة هي نتيجة للعقبات التي وضعتها الإدارة الجزائرية، ليس فقط أمام افتتاح مدرسة ثانوية فرنسية جديدة، ولكن بشكل خاص أمام مبادرات المؤسسات الجزائرية الخاصة لتوفير التعليم باللغة الفرنسية، كليا أو جزئيا».
وبالتالي يلاحظ النائب «حسرة العائلات التي لم تعد قادرة على إرسال أطفالها إلى المدرسة في بيئة ثنائية اللغة والذين أكدوا على وسائل مؤسفة للضغط على المؤسسات، مثل عمليات تفتيش الشرطة للتأكد من أن الحقائب المدرسية للأطفال لا تحتوي على الكتب المدرسية الفرنسية».
استبدال اللغة الفرنسية
وفي رغبة السلطات الجزائرية في محو اللغة الفرنسية من الحياة اليومية للجزائريين، هناك بالتأكيد مؤشر على العداء تجاه فرنسا، ولكن هناك أيضا رغبة في استبدال ثقافة بأخرى. «إن رفض السماح بتطور التعليم المدرسي باللغة الفرنسية أو الناطقة بالفرنسية» هو نتيجة، بالنسبة للمؤلف، «لاستراتيجية التعريب التي تم تنفيذها، على موجات متتالية، منذ ما يقرب من أربعين عاما والتي تقترن الآن بالرغبة في استبدال اللغة الفرنسية بشكل كامل باللغة الإنجليزية في الجامعة».
وللقيام بهذا التحول الكبير، لا تنوي السلطات الجزائرية التعهد بمواعيد نهائية طويلة الأمد. ألم يعلن وزير التعليم العالي الجزائري، بداية العام الحالي، أنه اعتبارا من بداية العام الدراسي 2023، سيتم تدريس جميع الدروس التي لم تدرس باللغة العربية باللغة الإنجليزية؟
قرار مثير للقلق للعديد من المحاورين الجزائريين الذين التقاهم النائب، لأن رغبة السلطات الجزائرية هذه لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع الواقع الأكاديمي لبلد حيث، على سبيل المثال، «تتم الدراسات الجزائرية في الطب باللغة الفرنسية».
كما أن «خيارات الطلاب الجزائريين الراغبين في إجراء دراسات في الخارج تتناقض بشكل صارخ مع رفض الحكومة، العلني أو الضمني، الدخول في تعاون جامعي مع فرنسا ». في الواقع، تستقبل فرنسا 79% من حركة الطلاب الجزائريين، متفوقة بفارق كبير على كندا وتركيا. وهكذا، فإن « الطلبة الجزائريين المتواجدين في فرنسا، والبالغ عددهم 32147، في بداية السنة الدراسية 2022-2023، يمثلون أغلبية الطلاب الأجانب، خلف المغرب وقبل الصين».
أمام هذه المواعيد الوهمية التي بدأت مع بداية العام الدراسي 2023، يعارض صناع القرار رغبتهم في الترحيب بالطلاب الأجانب وجامعة أميركية على الفور (ولكن دون الإعلان عن موعد حتى الآن)، ومن أجل استكمال عملهم التقويضي، مع الإعلان عن نهاية تنظيم التعليم العالي وفق نظام ليسانس-ماجستير-دكتوراه المتبع في الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل التقرب من النظام الأنجلوأمريكي.
لكن الفشل في الترحيب بهؤلاء الطلاب الأجانب وهذه الجامعة الأمريكية هذا الخريف، أدى إلى فرض حظر على أساتذة الجامعات والطلاب الجزائريين «من المشاركة في الملتقيات العلمية الدولية دون الحصول أولا على موافقة وزارة التعليم العالي الجزائرية» وذلك منذ شهر غشت 2023.
ولا يقتصر هذا «الاستبدال الكبير» على مجال التعليم، بل يؤثر أيضا على التعاون التقني بين البلدين. ويؤكد المقرر أن «الصيغة الأوروبية شرط مهم لفرنسا للمضي قدما في الجزائر» و«يوصي بأن تمنحه خارطة الطريق التي أعدها السفير مهمة تعبئة عمليات التعاون الأوروبي والاستفادة من القناة الأوروبية لنشر أدوات التعاون الفرنسي». وأوضح فريديريك بوتي أن «السبب هو أن الجزائر تقبل شراكات من هذا النوع عندما يبدأها الاتحاد الأوروبي رسميا، ولكن ليس كقاعدة عامة مع فرنسا». وهكذا، في الجزائر، اقتصرت الوكالة الفرنسية للتنمية على التبرعات منذ عام 2005.
المستقبل الوحيد لفرنسا في الجزائر يجب أن يكون بعيدا عن المؤسسات
إذا اصطدمت دبلوماسية السفارات، في الجزائر، بعدم اهتمام الشريك المؤسسي، أو حتى بعض توجهاته الاستراتيجية المعادية بشكل مباشر، فقد تمكن فريديريك بوتي، خلال رحلته إلى الجزائر العاصمة ووهران، من معرفة أن «شبكات التعاون الثقافي الفرنسي لا تزال قادرة على الفعل والمساهمة في إقامة علاقات بناءة بين المجتمعين الفرنسي والجزائري».
ولذلك فإن الاستراتيجية الفرنسية لتعزيز حضورها في الجزائر تتمثل في إقامة علاقات مع المجتمع المدني. وللقيام بذلك، يسرد فريديريك بوتي المزايا القليلة التي لا تزال تتمتع بها فرنسا في الجزائر، لا سيما عبر مصلحة التعاون والعمل الثقافي، أو شبكة المعاهد الفرنسية التي تضم خمسة فروع وستة عشر موقعا.
وتعتمد المقرر بشكل خاص على المعاهد الفرنسية للقاء الشباب والفنانين الجزائريين الذين يترددون باستمرار على هذه الأماكن، في ظل غياب الأماكن المخصصة للثقافة في البلاد. وهكذا، عندما تفشل دبلوماسية السفارات، تتم الإشادة بهذه القناة الثقافية التي تسمح لفرنسا بالحفاظ على التواصل «الجيد» مع المجتمع المدني.
وبغض النظر عن هذه القنوات الثقافية، فإن مصلحة التعاون والعمل الثقافي محدود للغاية في بلد حيث تؤثر الرقابة الإدارية بشكل كبير على الجمعيات، وحيث اضطر بعضها، مثل كاريتاس أو أطباء العالم، إلى وقف أنشطتها بسبب نقص الدعم. وبالتالي فإن هدف مصلحة التعاون والعمل الثقافي هو النجاح في «تعزيز العلاقات بين المجتمعين المدنيين الجزائري والفرنسي، حتى في ما يتعلق بالمسائل السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية التي يصعب التعبير عنها في الجزائر، وذلك من خلال الاعتماد على المبادرات المحلية الشجاعة» ولا سيما دعم الجمعيات النسوية التي تكافح العنف ضد النساء والفتيات، أو تقدم المساعدة للنساء المهاجرات.
وأخيرا، يتمثل التحدي أيضا بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية في «تحديد شخصيات المستقبل في الجزائر التي من المحتمل أن تساهم في إصلاح علاقاتنا». وبالتالي يتعين انتظار الزمن أن يعمل عمله لكي تطوى صفحة الكهلة الذين يتحكمون في النظام في الجزائر.





