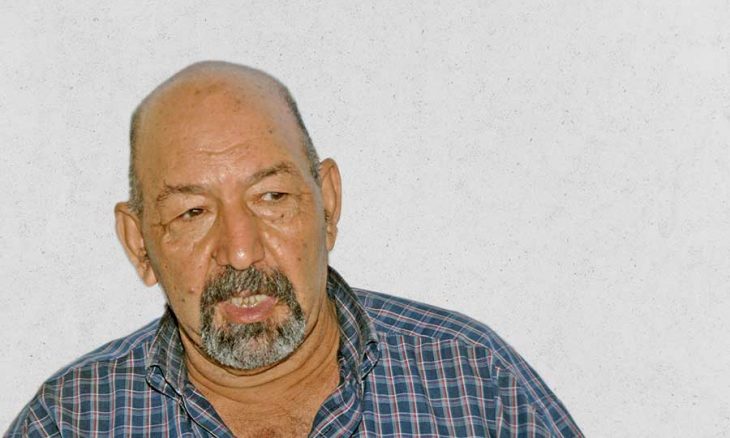حين يهُمّ المرء بالحديث عن هذا الشيء الذي نُسمّيه « السينما المغربيّة » يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: كم عدد الأفلام الجيّدة التي تصدر كلّ سنة؟ على أساس أنّ سؤالاً كهذا يُقيم حدوداً وسياجات بين الجيّد والرديء، بين الجميل والقبيح، بين الراقي والذميم وغيرها من الثنائيات اللفظية التي تُميّز الفنّ الأصيل عن نظيره الهشّ والمُتصدّع. لهذا فإنّ ثقافة الكمّ التي باتت تُراهن عليها الجهة الوصية على الشأن السينمائي غير صحيحة وتفتقر إلى رؤيةٍ واضحة. فإذا عُدنا إلى تاريخ السينما الغربيّة سنجد أنّها لم تُراهن يوماً على وفرة الإنتاج السينمائي، لكون الأفلام التي خرجت من تربتها كانت ذات ميسمٍ فردي له علاقة بسيرة الفرد داخل واقعه، وليس عبارة عن مشروع كمّي يُنتظر أنْ يُفرز منه بعض الأفلام الجيّدة.
حين كتب بودلير تُحفته الأدبيّة « أزهار الشر » لم تكُن فرنسا تعمل على خلق مشروع شعري فرنسي تُحاول بلورته داخل مؤسسة، بل خرجت الأشياء من جسد بودلير ومن تاريخه وذاكرته ووجدانه. هذا الأمر، ينعكس أيضاً على السينما، إذْ رغم محالة المرز السينمائي تأطير بعض المشاريع ووضع بعض الحدود والسياجات المُرتبطة بالدين والجسد، ثمّة أفلام معدودة على رؤوس الأصابع، تخرج من قبضة الأيادي الحديدية، محاولة أنْ تجترح لنفسها مكانة مميّزة داخل السينما عن طريق موضوعات جديدة وصُوَرٍ مُبتكرة مُؤثّرة في وجدان المُشاهد ومُتخيّله.
فهذا الخرق الذي تُمارسه بعض الأسماء، هو الذي ينبغي المُراهنة عليه على أساسا أنّه فنّ يفتح آفاقاً جديدة للفيلم المغربي، ويُخرجه من ثقافة التهريج الترفيهية والاستلاب البصري القائم على تقليد ومحاكاة سينما الآخر. فإذا استثنينا أسماء من قبيل: نبيل عيوش وفوزي بنسعيدي وهشام العسري ومحمّد مفتكر ومحمّد الشريف الطريبق وحكيم بلعباس، سنعثر على عشرات الصُوَر السينمائية التي تُعيد إنتاج سينما الآخر، ولا تطمح لا من قريبٍ ولا من بعيد ابتكار صور جديدة أكثر أصالة وتعلّقاً بالواقع الذي ننتمي إليه.
ثمّة تحوّلات كبيرة من الناحيتين الفنية والجماليّة داخل السينما المغربيّة، إلاّ أنّ هذه الأخيرة لم تستطع اجتراح مشروع جمالي خاصّ بها، تُظهر من خلاله نتوءات الواقع وقهر التاريخ وفداحة الذاكرة أو على الأقلّ الانطلاق من حكاياتٍ شخصية يجعلها المخرج تتماهى مع سردية الأحداث الكبرى التي تطال الواقع، كما هو الحال في سينما هشام العسري التي تنطلق من شخصيات مُحدّدة، فبقدر ما يُظهر بؤسها وشقاها، تتماهى في لحظةٍ ما مع صورةٍ الواقع بشكلٍ كامل.
إنّ السينما المغربيّة ستظلّ تربوية، إذا لم تُحاول الثورة على أرضية اشتغالها وتطمح إلى بناء سرديّة سينمائية تنتمي إلى واقعها وتاريخها.