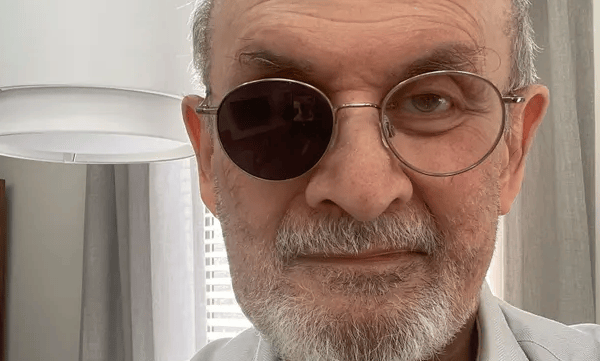والذي جعل منه الصديقي، مادة دسمة لصياغة أعماله المسرحية المُتعدّدة، بطرق يجعل فيها من التراث العربي، يذوب داخل النصّ المسرحي، وهذا النوع من التوليف الفني في أعماله المسرحية والتلفزيونية، بين كوميديا ساخرة وألم ورومانسية ومرارة قاتمة للواقع داخل نفس المشهد، جعلت أعماله مقبولة لدى المُشاهد العربي، الذي اعتبرها فتحاً فنياً وجمالياً داخل الكارطوغرافية المسرحية المغربيّة الغارقة في التقليد إبان ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم.
إذْ سيعمل الطيب الصديقي على تجديد النصّ المسرحي، لكنْ مع حفاظه التام على القالب المسرحي في شكله الحديث، بحيث أنّ التجديد ظلّ مُقتصراً في تجربته على الجانب الموضوعي وأبعاده الفنية والجمالية داخل بنية نصّ مُعتّق من جرار كلامٍ تُراثيّ، خاصّة وأنّ عشق الصديقي للغة العربيّة، جعله يطرق باب هذه النصوص بلغة عربيّة فصيحة ممزوجة أحياناً داخل بعض المشاهد بلغة الدارجة المغربيّة أو لغة الكلام الحية، التي يتوسّل بها الصديقي لخلق بعد الانفلاتات الفنية داخل نصوصه المسرحية.
وهذا الأمر، كسّر من منظور الرؤية قليلاً في تجربته، وجعلها مُنفلتة من قبضة مسرح وطني تقليدي، ينتقد أو يُحاكي المقاومة المسلحة ونضال الحركة الوطنية وأهوال الاستعمار وأسراره. لكن كل هذه المُغايرة والاختلاف التي طبعت أعماله، لم تكُن ستتأتى، إلاّ بدراسة الطيب الصديقي المُبكرة بفرنسا ومُعاينته اللصيقة للساحة المسرحية الفرنسية وقدرتها على تجديد نفسها من الداخل وليس باستعارة تراث الآخر أو لسانه.
من ثمّ، عمل مؤسّس فرقة المسرح البلدي، في جعل التراث العربي، مادة لتشكيل عوالمه المسرحية وخصوصيتها داخل المنطقة المغاربيّة والعربيّة، هذا إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه التلفزيون المغربي في تسجيل وبث أشهر مسرحيات الصديقي « مقامات بديع الزمان الهمداني » و »ديوان سيدي عبد الرحمان المجذوب » و« الحراز » وغيرها من الأعمال المسرحية، التي لاقت تجاوباً جماهيرياً داخل الشاشة الصغيرة، لما فطنت له مُبكراً من تحوّلات تقنية وجمالية عن ضرورة نقل هذا التراث المسرحي وأعلامه إلى شاشتها الصغيرة.
غير أنّ المجد المسرحي الذي حقّقه الصديقي داخل التلفزيون المغربي، بدا في لحظة من مساره الفني وكأنّه « نقمة » على أعماله الأخرى التلفزيونية والسينمائية منها، والتي لا تقّل أهمية عن نصوصه المسرحية، إذْ أنّ نجاح وارتفاع وهج هذه الأخيرة عربياً، حجب قيمة هذه الأعمال التلفزيونية، التي تظّل علامة فارقة في تاريخ التلفزيون المغربي إلى حدود الآن، بحيث أنّها تجاوزت 30 عملاً تلفزيونياً، مُتفاوتة التقنية ومُختلفة من حيث المعالجات الدرامية والجمالية، مع العلم أنّ أغلبها، لم يخرج من السياق التاريخي والسياسي والاجتماعي، الذي كان يرزح تحته المغرب بعد الاستقلال، إذْ ركز فيها الصديقي على جملة تحوّلاتٍ خفية، بدأت تُطاول المجتمع المغربي الغارق في التقليد والطامح إلى حداثة فنية مُتصدّعة، بين التشبث بالجذور المغربيّة والانطلاق منها لصياغة مشروعٍ فنيّ للتلفزيون المغربي أو التخلي عن ذلك نهائياً لصالح تبعيةٍ عمياء للتلفزيون الغربي.
هكذا نجحت أعماله التلفزيونية الأولى في تقريب أواصر الصداقة، بين الواقع والخيال والبادية والمدينة والطبقة الوسطى والفقيرة، عبر قصصٍ وحكايات مُستلة من الواقع المغربي وآلامه، لكنها ضمنياً وعلى المستوى الجمالي، ظلّت تتقاطع مع موضوعات كبرى، كانت تعيشها الساحة العربيّة وأيضاً مع هاجس التجريب والتحديث وشواغل حداثةٍ فنية عربيّة، بدأت ملامحها تظهر منذ بداية الثمانينيات داخل بعض الأفلام التلفزيونية العربيّة.
ولكنه وهو يُقارع ويُساجل فنياً وجمالياً التلفزيون المغربي، سواء كممثلٍ أو مُؤلفٍ، ظلّ الصديقي حاضرٌ بقوّة أيضاً داخل الشاشة الكبيرة العالمية في أرقى مُنجزاتها السينمائية من خلال بعضٍ من أدواره الشهيرة بفيلم « الرسالة » لمصطفى العقاد و« الدجاجة » لجون فليشيت و »أطفال الشمس » لجون سيفراك، هذا إضافة إلى عشرات من الأفلام السينمائية المغربيّة والعربيّة، التي وسمت مسار الطيب الصديقي كمُمثل وجعلته يأخذ صفة فنّان شموليّ مُتعدّدٍ، بين فنون الخط والتمثيل والتأليف المسرحي والتلفزيوني والسينما.
هذه الأخيرة، استطاع عبرها تأليف فيلمه الخالد « الزفت » سنة 1984 وهو من فيلمٌ مُقتبس عن مسرحية « سيدي ياسين في الطريق » يُعد اليوم أحد أبرز الأفلام في تاريخ السينما المغربيّة، بسبب قدرته الهائلة في جعل صُوَرِهِ تبدو أكثر حقيقة، فهي تدخل في عملية سجالٍ فنيّ مع الواقع المغربي زمن نهاية السبعينيات والتحوّلات الحساسة التي مرّ منها البلد سياسياً واجتماعياً، ونظراً إلى فطنة الصديقي الفنية، استطاع من خلاله التسلّل إلى وجدان المغربي المقهور والقبض عن مآزق السياسة والدين والاجتماع والتخلف والتقليد.
وبالرغم من قوّة الفيلم الشكلية والجمالية، لم يحقّق أيّ اهتمامٍ يُذكر من لدن الجهات الرسمية، باستثناء عشاق الفنّ السابع، الذين ظلوا يرنون إليه، كلّما ضاقت بهم سُبل الإنتاج التلفزيوني الجديد، وعدم قدرة هذا الأخير، على إنتاج صُوَرٍ فنية مُتخيّلة، بقدرما تُقيم في واقعها موضوعياً، تبتعد عنه في آن واحدٍ جمالياً، وذلك من خلال جعل هذا الواقع وحكاياته وسردياته يتموضع داخل بنية الخيال، الذي تعمل الكاميرا تقنياً على تذويبه داخل « صورة »، يُصبح عبرها ذا أبعادٍ فنية ورمزية في الذاكرة الجمعية.