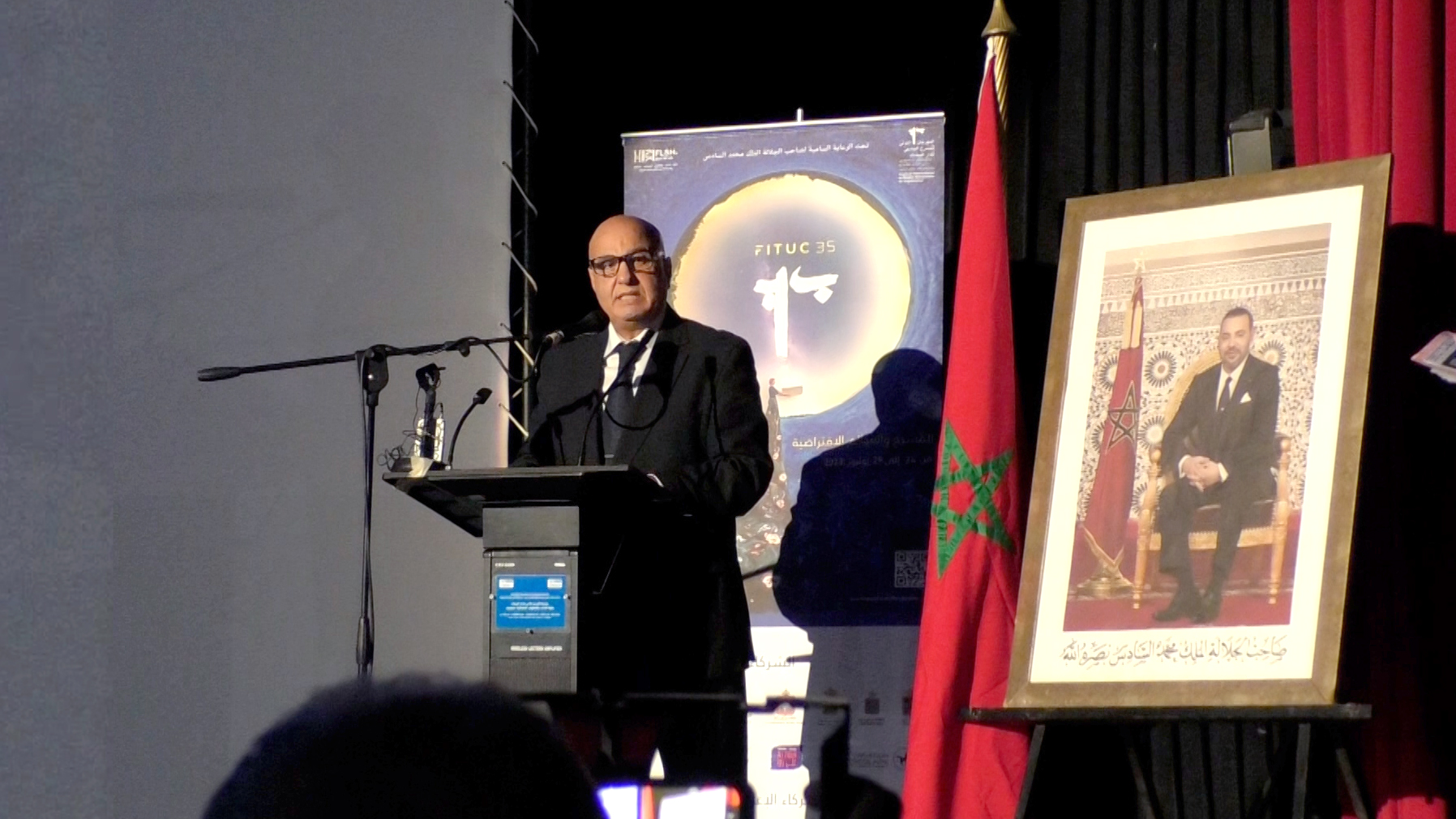حين يزور المرء مدينة الفقيه بن صالح في شهر غشت من السنة، يشعر وكأنّه في جهنّم مُصغّرة على الأرض. بل إنّ أهلها مُعذّبون فوق هذه الأرض، التي لا تتوقّف الشمس عن حرق أجسادهم. لاشيء في المدينة سوى الشمس. إذْ يستغرب المرء كيف لمدينة في حجم ذاكرة الفقيه بن صالح، أنّها لا تتوفّر على مسابح كبيرة وحدائق جذابة، بما يجعل الساكنة يستمتعون فيها خلال فصل الصيف. فمنذ العتبة الأولى لدخول المدينة ترى الناس ليلاً مستلقية أمام شرطة بوابة المدينة على أرصفة خضراء، لا أثر فيها للراحلة ولا للاستجمام. ومع ذلك فهي الفضاء الوحيد الذي تحجّ إليه الساكنة.
لكنْ كيف يجوز أنْ تُصبح مداخل المدينة مُتنفّساً سياحياً وحيداً للساكنة؟ هذا الأمر، يدلّ على أنّ البؤس أصبح علامة وجودية تنطبع بها المدينة، وذلك في مشاهد ساخرة ترُجّ الوجدان. من الغريب عدم وجود أي مخطّط استعجالي لتنمية المدينة، باعتبارها من الروافد الأساسية في المغرب على المستوى الفلاحي. بل إنّ هذا العنصر يمكن استغلاله في معارض متنقلة بالجهة والتعريف بالمواد الفلاحية وخيراتها. لكنّ الغريب أنّ الساكنة نفسها يبدو وكأنّ لا شيء يعنيها، لكون نصفها يعيش بين إيطاليا وإسبانيا. وبالتالي، فهي تُمثّل بالنسبة لهم مجرّد نقطة للعودة من أجل الراحة خلال فصل الصيف، فهم لا تعنيهم تنمية المدينة، بما أنّهم يحملون في جيوبهم حفنة من الأورو، تجعلهم بمثابة أمراء يتنقلون بسيارتهم الفارهة وسط أجساد الفقراء.
لم يُفكّر شباب المدينة وأعيانها في تنميتها سياسياً وثقافياً وفنياً، ما يجعلنا نتساءل: أين تلك الجمعيات التي تتناسل كالفطر، كلّما حان وقت الدعم؟ كيف يُمكن العيش في مدينة، بدون عروض مسرحية وأفلام سينمائية ولقاءاتٍ أدبية؟ ألا يجدر بالأساتذة والمعلمين وجمعيات المجتمع المدني قيادة المدينة من الناحيتين الثقافية والفنية؟ لقد شحّت الممارسات الثقافية والأنشطة الفنية من المدينة وأصبح الناس يعيشون على ماضيها وذاكرتها. فالحديث الثقافي بالمدينة مُرتكز حول أسماء لامعة طبعت المدينة منذ نهاية السبعينيات، في غيابٍ تام للأجيال الجديدة. لكنْ حين نقول الأجيال الجديد، فنحن نتحدّث عن الأسماء الشابة الحقيقية التي تُقدّم جديداً يُعوّل عليه في مجالات تتعلّق بالكتابة والمسرح والسينما والموسيقى والرقص، وليس تلك التي تمُرّ سريعاً من المشهد، فتُنسى كأنّها لم تكُن يوماً بتعبير الراحل محمود درويش.
حين بدأت الكتابة وأنا في سن 12 عاماً، كانت الفقيه بن صالح أشبه بمختبر معرفي تجد فيه التلاميذ يتنافسون فيما بينهم لتقديم الأفضل لمدينتهم في مجالات تتعلّق بالشعر والقصّة والتمثيل والرقص والغناء. ورغم أنّ لا أحد كان مُهتمّاً بما كنّا نُقدّمه بين الأزقّة والشوارع، كان الرفاق يتفاعلون مع هذه الوجوه الشابة التي تُحاول التعبير عن ذاتها وأحلامها. لم نكُن نملك شيئاً باستثناء أقلامنا، كما لم يجد باقي الأصدقاء خشبة لتقديم مسرحياتهم الأولى. لقد كانت حديقة البلدية خلال الصيف والشتاء المكان الوحيد الذي نرنو إليه لقراءة الشعر وعزف الموسيقى والرقص. لم نملك إلاّ أحلامنا التي بها نُضيء مصيرنا البائس داخل مدينة تبدو وكأنّها مستيقظة من عدم أزلي.
إنّ الشباب وقود المدن، فهم من يجعلون مدنهم تبقى حيّة في وجدان الساكنة. إنّهم أورفيوس الحياة اليوميّة، حيث يُصبح للحياة معنى خلال فصل الصيف. لا توجد جمعية واحدة ندّدت بضرورة إقامة المزيد من اللقاءات الثقافيّة والعروض الفنّية وسهرات غنائية وبناء مسابح ترفيهية كبيرة ورائقة، تجعل الناس يستمتعون بيومياتهم خلال فصل الصيف، لأنّهم يستحقّون بناء كلّ ما هو جميل على هذه المدينة العصية على المحو والنسيان.