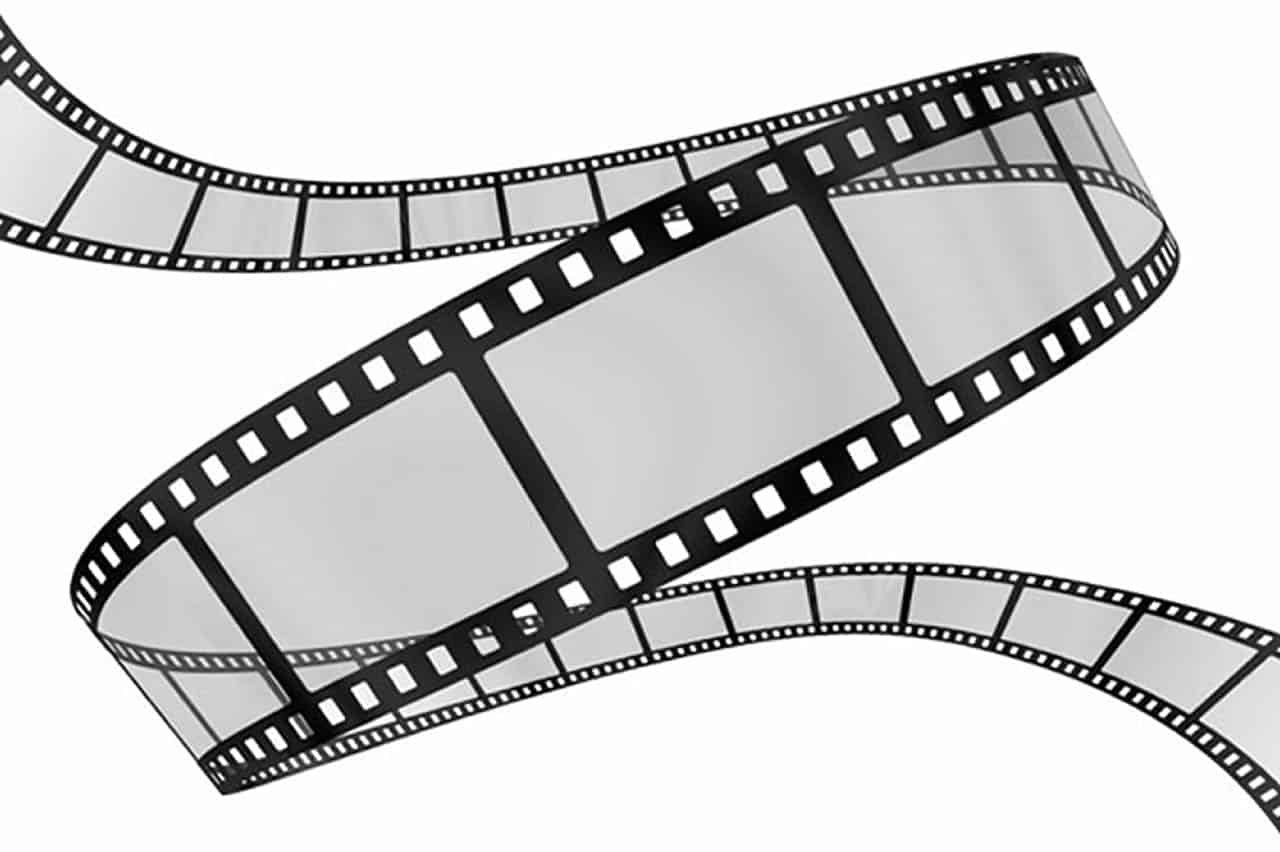تبرز هذه قيمة هذه العلاقة في إمكانات الشعر اللامحدودية في البحث عن مواطن أخرى للسؤال. رغم أنّ هذه العلاقة تبق مُحتشمة بالنّظر إلى الثقافة الغربية المعاصرة التي استطاعت تجارب شعرية كثيرة الانفتاح على محترفات الفنانين التشكيليين وفهم مناخاتهم الإبداعية. وكانت تلك اللحظة جد هامة داخل الثقافة الغربية، لأنها كسّرت كافة الحدود والحواجز، بعدما غدت الفنون تتعانق بين بعضها البعض. كما اعتبرت مؤسسة في تاريخ العلاقة بين الشعر والتشكيل. ومنذ تلك اللحظة أصبحنا نقرأ كتاباً نفيسة يتم فيها المزج بين التعبيري الشعري بالتوليف البصري، حيث القصيدة تتماهى مع الصورة والاستعارات مع الألوان والمجازات مع كتل المادة وبقعها اللونية. إنّه نوعٌ آخر من المثاقفة التلقائية، حيث يستفيد كلّ واحد من الطرف الآخر. وهذا الأمر، ساهم في ظهور العديد من المؤلفات التي تُعنى باستشكال جماليات العلاقة وأشكال التعبير الشعري بنظيره الفنّي. هذه المؤلفات رفعت من منسوب أهمية العلاقة، بعدما غدت دور النشر الغربية، تُراهن على مثل هذه الكتب التي تعتبرها أفقاً حداثياً بالنسبة للشاعر.
اليوم مانزال داخل العالم العربي، لا نتوفّر على هذا النوع من الكتب، إذْ هناك تجارب قليلة، لكنّها لم تستطع أنْ تُبلور أفقاً فكرياً جديداً لتاريخ هذه العلاقة داخل بيئة الثقافة العربية، كما لو أنّ الأمر يتعلّق بتجربة تقليدية لا ينبغي استعادتها. من المآزق والإشكالات التي طبعت سيرة هذه العلاقة، تكمن في رداءة الطبع، ذلك إنّ التجارب الأولى التي طالعتنا منذ بداية الثمانينيات، لم تكُن طباعتها جيدة بما يضمن حقوق الفنان على مستوى جماليات العمل. فكانت أغلب الأعمال باللون الأسود، ولا تُظهر أيّ جاذبية بالنسبة للعين. لكنْ في السنوات الأخيرة وما تقدّم الطباعة والتصميم، أصبحت تُطالعنا أعمالٌ شعرية فنية تزيد من عمق هذه العلاقة، أعمال يتماهى فيها قوّة التعبير الشعري بنظيره البصري. إنّهما معاً يُقيمان في اللامنتهى الذي بقدر ما تنتهي فيه سُلطة الكلمة الشعرية، حتّى تبدأ فتنة ورحابة اللوحة المسندية وجمالياتها.
نحتاج اليوم في غمرة هذه التحولات التي تعرفها الثقافة المغربية، الانفتاح أكثر على الأشكال الفنّية ومحاولة خلق جديد يُعوّل عليه ثقافياً. إنّ التكرار الذي يطبع الثقافة المغربية من ناحية الموضوعات والإشكالات والقضايا، يجعلها تموت تلقائياً ويطغى عليها الجمود والتعفّن.