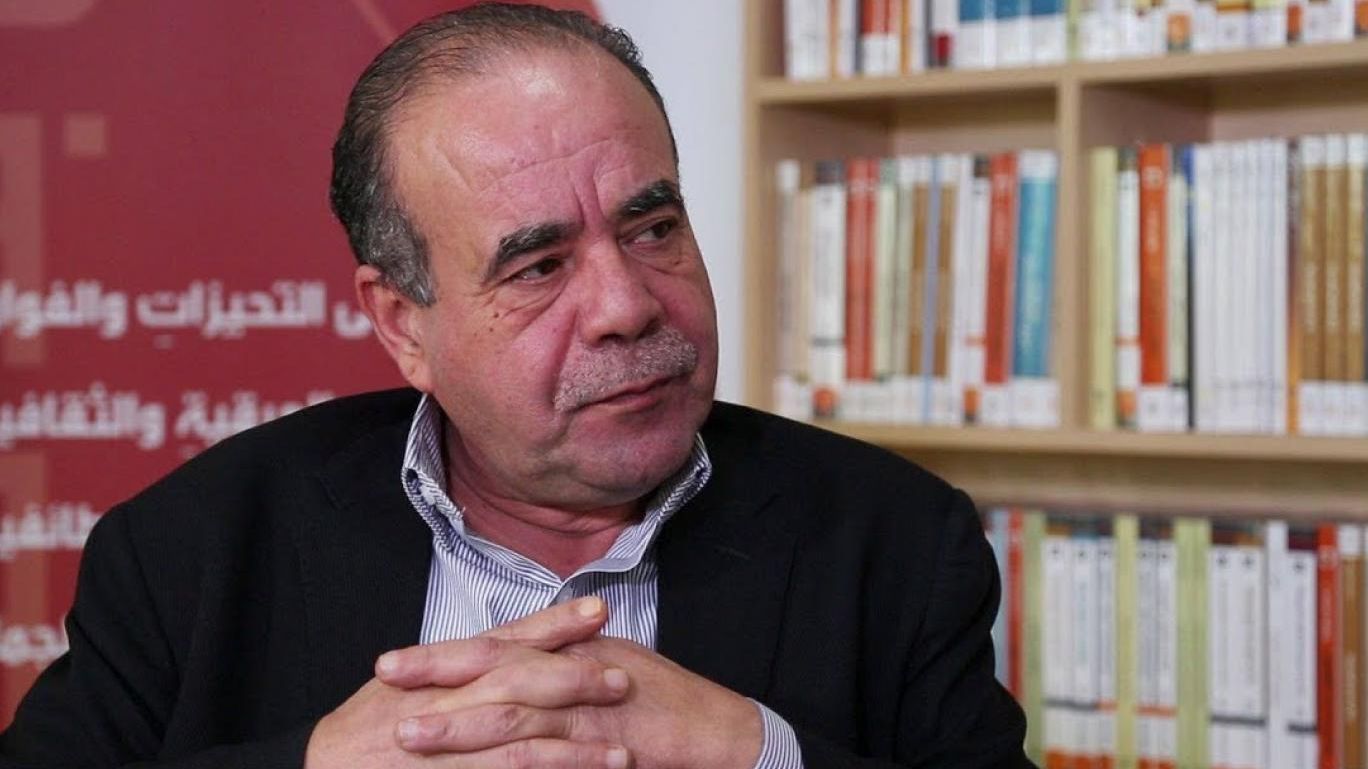هذا وتجدر الإشارة بأن عبد الواحد كفيح، يُعدّ من أهم الروائيين وكتّاب القصّة في المغرب، بحكم ما راكمه من تجارب إبداعية هامّة منذ بواكيره القصصية الأولى كـ: "أنفاس مستقطعة" و"رقصة زوربا" و"رسائل الرمال" قبل أنْ يتّجه صوب كتابة الرواية من خلال "روائح مقاهي المكسيك" و"أتربة على أشجار الصبّار".
إلاّ أنّ انتقال كفيح من القصّة إلى الرواية، لم تمليه أيّ دوافع مادية تتمثّل في الحظوة المركزيّة التي بات يحتلّها جنس الرواية داخل بعض المؤسّسات الثقافية بالعالم العربي، مقارنة مع أجناس أدبيّة أخرى كالقصّة والشعر، بقدر ما قادتها دوافع فكريّة مُتمثّلة في قدرة الرواية على احتواء أجناس أدبيّة وإمكاناتها المُذهلة على مُستوى التخييل. سيما وأنّ صاحب "تناغمات نصّية" يمتلك عدّة حكائية طويلة قادته منذ نهاية ثمانينيات القرن الـ 20 إلى أنْ يغدو وجهاً أدبياً أصيلاً داخل تربة الإبداع في المغرب، وعموداً من الأعمدة التي ينبني ويُشيّد عليها أدب الهامش.
هذا وتدور الرواية حول نمطٍ من المقاهي الشعبيّة القديمة بمدينة الفقيه بن صالح من خلال اعتماد تقنية الفلاش باك السينمائية، بما جعل الرواية على مُستوى الحكي تتأرجح بين الحاضر والماضي بلغةٍ أدبيّة يغلب عليها الوصف والسخرية في سبيل تقديم صورةٍ منسيّة من قبضة الوعي الجمعي المغربي اليوم. لكنْ في غمرة القبض عن المنسيّ داخل هذه المقاهي، يُشرّح عبد الواحد كفيح جملة من القضايا الاجتماعية والإشكالات النفسية في محاولة الكشف وتلمّس مظاهر العطب الذي ألمّ بحياتنا الاجتماعية.
وإذا كان كفيح لا يدّعي أيّ بعدٍ فكريّ في صناعة روايته، فإنّ الكتابة ذات نمطٍ أنثروبولوجي من خلال استحضار متخيّل المقهى وما يحبل أعطابٍ وتناقضاتٍ. لهذا قد تكون "روائح مقاهي المكسيك" أهمّ الرواية التي استحضرت الموروث الشعبي وأعادت الاشتغال عليه وفق رؤية أدبيّة مُبتكرة، لا تتعامل مع التراث باعتباره إكسيسوار خارجي، بل بوصفه فكراً يحفر مجراه عميقاً في جسد الشخصيات وفضاءاتها المعتمة.
يقول كفيح عن فضاء الرواية: "كانت مقاه شعبية أبوابها مشرعة على الدوام، تؤوي من لا مأوى له. إنها مأوى الحشاشين والسكارى والمشردين والمقامرين والأفّاقين والسماسرة ولاعبي الثلاث ورقات والحمقى والمعتوهين والجواسيس والغرباء ومروجي الإشاعات والمساجين والشواذ وعابري السبيل. رواد المقهى أناس بسطاء، فاشلون، مختلفون في المهن والأفكار والأذواق، يستحلون الثرثرة واحتساء القهوة وافتعال المناوشات والمشاحنات العنيفة، فيقتتلون قعوداً على الحصر في مباريات لعبة الورق، يحتسون الشاي البارد، أو قهوة عفنة عطنة من عصير الشعير المحروق، يزدردون لحم الناس في ثرثراتهم بالغيبة والنميمة وهم مكدسون حول طاولة كبيرة جعلوها ساحة للعبة الورق، التي لا تنتهي أشواطها الإضافية إلا بالقمار والصراخ والتصايح والتراشق بالألفاظ النابية التي تتحول إلى حلبة للمصارعة العنيفة، فلا تسمع عادة إلا الزحار والطّحار والأنات الدفينة في الحناجر، ونطحات الرؤوس الكتومة، والاشتباك بالأيدي.
يضيف "ولأنها كانت هكذا، تشتعل بها الحرائق سريعاً، وتنتهي سريعاً، أطلق عليها مقاهي المكسيك عوض مقاهي الشعب. أما القاطنون، فكانوا من الغرباء البدو الذين لا يعرف لهم أصل ولا فصل، لا مناطق انطلاقهم، وإلى أين هم ذاهبون، وأي زاوية وركن من الأرض هم قاصدون. غرباء رحّل كالغجر، أو الهنود الحمر. رجال ونساء، من الأعراب والبربر، نزحوا من القرى فراراً من شدة الجدب وغدر القحط، محملين بالأكياس والحقائب، والصرر والأطفال العراة على الأذرع، أو مشدودين كالحرادين على الظهور. يكترون غرفاً للمبيت، فتراهم ملتئمين حول المواقد كعبدة النار المقدسة. وكان أغلب هؤلاء من الحصادين، الذين ينزلون هناك، كقطعان البقر الجافلة، يقضون ليلة مقدارها خمسون ألف سنة. تجتاح الفضاء زوابع صخب يتحول إثرها مقهى المكسيك لحلبة الاقتتال، وينقلب عاليها سافلها فينتشرون في أرجاء المقهى مرميين على ظهورهم وأرجلهم منفرجة متناثرة من أثر العياء، كرعاة البقر، وقد غطوا وجوههم بـ"تارازات" أسطوانية الشكل تشبه قبعات المكسيك، ومن هنا جاءت التسمية".